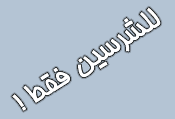يُعرف العلماء اللغة بأنها أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم، لها دلالاتها ورموزها، وهي قابلة للنمو والتطور، تخضع في ذلك للظروف التاريخية والحضارية التي يمر بها المجتمع.
أما لغتنا العربية فهي فخر وعز لنا؛ إذ خصها الله عز وجل بأن خلدها في "القرآن الكريم"، وأراد لها أن تكون لغة الإسلام ولغة أهل الجنة.
يحق لنا أن نفتخر بها، وأن نعلنها لغة التواصل فنتعايش من خلالها، وعار علينا أن نستبدل بها الذي هو أدنى منها، فنختار لغة أخرى نعبر فيها عن غاياتنا وما نريده؛ لغة "المصالح" التي اتفق أهل الكتابة على تسميتها باللغة، والتي تفشت وانتشرت حتى غدت لغة معترفا بها، يتم التواصل والتفاهم من خلالها، فاكتسبت مع مرور الوقت مشروعيتها على أرض الواقع.
و"المصالح" هي لغة قديمة قدم اللغة، تعبّد الطريق أمام الخطى للخطأ، وتسوغ له المبررات.
لغة المصالح هي ما جعلت كفار قريش يكفرون رغم جلاء الحق أمام أعينهم، فأردتهم في النار، وهي ذاتها اللغة التي تجعل الفساد ينتشر في البلاد. وبها تُحلل السرقات وتضيع الأمانات، وهي ذاتها التي تجعل غزة محاصرة، والمعابر مغلقة والقدس أسيرة إلى الآن بأيدي الصهاينة.
وبين تقارب المصالح وتضاربها تضيع حقوق، وتؤكل حقوق، فيما تتم المناداة لدى البعض بتغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، وفي هذا خير ما لم تكن المصلحة العامة مطية لغوية لتحقيق المصلحة الخاصة.
لغة لازال في حاضرنا من يرفضها. فلن ينسى التاريخ علماء أعفوا من مناصبهم، وآخرين هاجروا من مواطنهم، وهجروا عزهم الدنيوي مبتغين وجه الله تعالى، ولن ينسى التاريخ موقف أردوغان من الكيان الصهيوني ومجازفته بالمصالح التركية الإسرائيلية أيام الحرب على غزة، ولن تُمحى صورة أبو تريكة "بفانلته" التي يصر أن يعلن للعالم من خلالها وعبر نجاحه كلاعب رياضي بأنه مسلم ويحمل قضايا أمته،.. ونماذج أخرى كثيرة نعتز بوجودها بيننا.
إذ إن لغة المصالح ليست حكراً على الرؤوساء أو الوزراء أو أصحاب المناصب العليا، وإنما هي تعنينا جميعاً، فلينظر كل منا إلى نفسه وليحاسبها، هل حالت بينه وبين إحقاق الحق مصلحة له أو لمن يخصه، أو منكر لم ينكره لأنه يتعارض مع مصلحته، أو لم يقم العدل وساهم في الظلم تخوفاً على المساس بمصالحه وأعماله. فلنقف وقفة صادقة مع أنفسنا، ولنعلم أننا لن نفلح ولن يصلح حالنا ما دامت لغة المصالح هي أبجديتنا.
ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، حين اجتمع عتبة بن ربيعة، وشيبة بن ربيعة، وأبو سفيان بن حرب وغيرهم من رؤساء قريش وقالوا:"ابعثوا إلى محمد". فبعثوا إليه أن:"أشراف قومك قد اجتمعوا بك ليكلموك، فأتِهِم". فجاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم سريعاً، وهو يظن أن قد بدا لهم فيما كلمهم فيه بداء. وكان عليهم حريصاً يحب رشدهم، ويعز عليه عنتهم، حتى جلس إليهم فقالوا له: "يا محمد، إنا قد بعثنا إليك لنكلمك، وإنا والله ما نعلم رجلاً من العرب أدخل على قومه مثل ما أدخلت على قومك، لقد شتمت الآباء وعبت الدين وشتمت الآلهة، وسفهت الأحلام وفرقت الجماعة، فما يعنى أمر قبيح إلا قد جئته فيما بيننا وبينك، فإن كنت إنما جئت بهذا الحديث تطلب به مالاً جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالاً، وإن كنت إنما تطلب به الشرف فينا، فنحن نسودك علينا، وإن كنت تكون تريد به ملكاً ملكناك علينا، وإن كان هذا الذي يأتيك رئيْاً تراه قد غلب عليك بذلنا أموالنا في طلب الطب لك حتى نبرئك منه أو نعذر فيك". فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما بي ما تقولون، ما جئت بما جئتكم به أطلب أموالكم، ولا الشرف فيكم ولا الملك عليكم، ولكن الله بعثني إليكم رسولاً، وأنزل علي كتاباً، وأمرني أن أكون لكم بشيراً ونذيراً فبلغتكم رسالات ربي، ونصحت لكم، فإن تقبلوا مني ما جئتكم به، فهو حظكم في الدنيا والآخرة، وإن تردوه عليّ أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم"رواه ابن هشام في السيرة، وابن كثير في البداية.